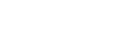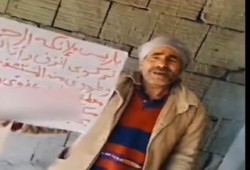يطرح ديفيد بن باسات في مقاله بجريدة جيروزاليم بوست سؤالاً مركزياً حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أنّ تصريحات مثيرة للجدل وردت مؤخراً في بودكاست عربي شهير يُدعى الطريق تكشف جانباً مختلفاً من العقيدة الأمنية المصرية.
ففي الحلقة، تحدّث طيّار مصري سابق بصراحة عن عملية “طوفان الأقصى” والحرب في غزة، موضحاً أنّ القاهرة لا ترى في القطاع مشكلة تحتاج إلى حل بل ترى بها استراتيجية لإبقاء الصراع مع إسرائيل واستنزافها.
وأوضح أنّ غزة، من منظور مصري، تؤدي دوراً محورياً في إطالة أمد النزاع حتى تُستنزَف إسرائيل عسكرياً ونفسياً.
يشير الكاتب إلى أنّ المصدر الذي نقلت عنه جيروزاليم بوست أضاف أنّ موقع إسرائيل الجغرافي يجعلها بلا عمق استراتيجي، وهو وضع ينبغي -برأيه- الحفاظ عليه كي تبقى “ضعيفة ومعرّضة للتهديد”.
وترافق هذه الرؤية الأمنية مع واقع ميداني جديد، إذ تجاوزت مصر منذ أكثر من عقد القيود الصارمة التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بشأن انتشار القوات في سيناء.
ورغم أنّ الهدف المعلن هو مواجهة نشاط تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، فإن حجم التسليح المصري هناك – من دبابات وأنظمة دفاع جوي وقوات مدرعة – خلق واقعاً عسكرياً مغايراً تماماً لما نصّت عليه الاتفاقية.
المقال يوضح أنّ إسرائيل قدّمت دعماً استخبارياً وأمنياً لهذا الانتشار بحجة مواجهة الإرهاب، إلا أنّ تصريحات الطيار السابق في بودكاست الطريق تبيّن أنّ القاهرة ترى هذا الوجود العسكري أيضاً كورقة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة تل أبيب.
وهكذا يبرز التناقض بين إطار “السلام الرسمي” وبين عقلية عملياتية وأيديولوجية تعتبر إسرائيل خصماً محتملاً لا شريكاً استراتيجياً.
ثم ينتقل الكاتب إلى الجانب الاقتصادي، حيث تواجه مصر أزمة طاقة خانقة جعلتها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
فقد وُقّعت عقود بعشرات المليارات لتوريد الغاز الإسرائيلي، الذي يؤمّن لمصر دخلاً مهماً عبر إعادة التسييل والتصدير إلى أوروبا، إضافة إلى تغطية جزء من احتياجاتها الداخلية.
وبالنسبة لتل أبيب، يعدّ ذلك شراكة اقتصادية استراتيجية، بينما تنظر القاهرة إليه كضمانة للاستقرار الاقتصادي وأداة نفوذ مستقبلية.
هذا الاعتماد يولّد مفارقة، فمصر تحتاج اقتصادياً إلى إسرائيل لكنها سياسياً وعسكرياً تسعى لإبقاءها ضعيفة.
ويصف بن باسات هذه الاستراتيجية بالسياسة “المزدوجة” التي تتيح لمصر تحقيق مكاسب على المستويين: استمرار إمدادات الطاقة من جهة، والحفاظ على خطاب ومواقف حادة تعكس مشاعر الشارع العربي والمعارضة الإسلامية من جهة أخرى.
فالتعاون مع إسرائيل يثير رفضاً شعبياً يُنظر إليه كخيانة، ما يدفع القيادة المصرية إلى تبني نهج “السلام البارد” حيث تُبرم الاتفاقيات ولكن تبقى مشاعر العداء حاضرة.
ويضع الكاتب هذا السلوك المصري في إطار أوسع من أنماط السياسة الإقليمية، حيث توقع دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل لكنها في الوقت نفسه تحرص على الحد من نفوذها الإقليمي، وهو ما يشكّل نوعاً من “التوازن” القائم على الاعتراف الرسمي مقابل إدامة الضغط والقيود غير المعلنة.
الطيار المصري السابق لم يكن استثناءً في الطرح، بل قدّم مؤشراً إضافياً على أنّ التفكير الاستراتيجي في القاهرة لا يقتصر على مكافحة الإرهاب في سيناء بل يمتد ليُبقي إسرائيل تحت تهديد دائم.
ومع هذا، يذكّر الكاتب أنّ التعاون الاستخباري والاقتصادي لا يعني بالضرورة تغيّراً جوهرياً في نظرة مصر الأمنية. فالتناقض بين السلام المكتوب والواقع العملي على الأرض يبقى واضحاً.
ويخلص المقال إلى أنّ على إسرائيل إعادة تقييم افتراضاتها بشأن علاقتها مع مصر.
فالشراكات الاقتصادية في مجال الغاز والبنية التحتية، رغم أهميتها، لا تُلغي حقيقة أنّ المؤسسة العسكرية المصرية تبني قدرات متزايدة في سيناء وتتعامل مع غزة باعتبارها أداة استراتيجية لاستنزاف إسرائيل.
ومن هنا، يرى بن باسات أنّ التحدي أمام تل أبيب يكمن في الموازنة بين المحافظة على التعاون الاقتصادي الحيوي وبين إدراك إشارات العداء الكامنة في السياسات الأمنية المصرية.
بودكاست الطريق – بحسب المقال – أتاح نافذة نادرة لفهم تفكير دوائر في القاهرة ترى في غزة أكثر من مجرد بؤرة توتر محلية، بل ركيزة في معادلة القوة الإقليمية.
ومع الوجود العسكري المصري المتصاعد في سيناء والاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي، تظل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب معقّدة، تُظهر وجهاً اقتصادياً تعاونياً ووجهاً سياسياً وأمنياً يحمل الريبة والخصومة.
السلام بين الجانبين قائم، لكنه بعيد عن أن يكون سلاماً خالياً من التهديدات.